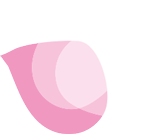أتذكر عدد المرات التي استوقفتني فيها كلمات تلك الأغاني الرنانة التي يجتاح صيتها كل الحدود ويملأ الآفاق، وتتخلل أنغامها حساباتنا الشخصية وبرامجنا المفضلة للاستماع، وتتصدر قوائم الأغاني الأكثر استماعًا على تلك البرامج لأعوام. أتذكر وقع الكلمات الغريب عندما اسمع “وأنا لو حلوة أنا حلوة عشان وياك” وأشعر بقوة هذا التصريح وكأنه حقيقة مطلقة، يتبعها تأكيد المحبوب على أهم ما تقوم عليه هذه الحقيقة فيقول بنشوة عاشق هائم: “حتى لو تحب ثاني بشارك من يحبك فيك“، وبهذه الصورة تُقولب المشاعر، وتحط من قيمتها، وتصوّر على أنها شكل من أشكال المرض -الطبيعي- الذي يجب علينا أن نعاني منه ولابد له أن يستمر “أنا مريضة اهتمام…ما بدي اشفى” فتلك الرغبة بعدم الشفاء يُعض عليها بالنواجذ، لأنها هي دافعنا الوحيد للشعور بالثقة والأهمية، ولا مفر منها سوى الرضوخ لأقل القليل، يرتفع بهذا الرضوخ صوت الجمهور المتلهف “كل اللي طالباه إني أحس بحبة اهتمام“. ويختم الفنان ذو المشاعر المرهفة حفلةً موسيقية يردد فيها وابتسامة تعلو الوجوه وتملأ القلوب “كي تكوني في عيوني وبس فيني ومو بدوني مذهلة.” وأسأل نفسي، كيف لا يستوقف أيّ منّا الكلمات التي تتردد في تلك الأغاني؟ كيف ننغمس في الاستماع لها دون أن نفكر بوعي في تحليل مفرداتها؟ كيف لا ننتبه أن هذا الهراء لا يمكن ترديده ولا يجب تعاطيه كونه صورة من صور الفن أو حتى شكل من أشكال الرومانسية الهوليودية؟ وأن سموم هذه الرسائل المدسوسة في عسل الهيام والغرام ما هي إلا شكل من أشكال السُلطة اللغوية علينا كنساء، ولا ينبغي لهذه السُلطة أن تمتلك زمام الأمور أو حتى أن تساهم في تشكيل صورتنا عن ذواتنا أو قيمتنا الفعلية أو عن كيف يجب أن تكون مشاعرنا وتقديرنا لأنفسنا.
لو قمنا بتحليل رسائل أي عمل فني غنائي بمنأى عن أي مشتت قد يؤثر على آرائنا وأفكارنا، لأدركنا مدى بشاعة اللغة المستخدمة في بعض الأغاني، لغة وإن اختلفت أحرفها يجمعها ذات الصفات، لغة تهين المرأة وتقلل من قيمتها ومشاعرها، لغة تدعم القالب الاجتماعي والهوية التي صممت لتتناسب مع صورتها النمطية التي لم تتدخل النساء في تكوينها، لغة تكرر أن المرأة لن تكون كاملة أو جميلة أو حية إلا بوجود محبوبها وحضوره. لغة تصر على أن المرأة لا سبيل لها للعيش إذا لم يحبها العاشق في نهاية المطاف، لغة تشجع على الدعاء بالموت على الحبيب الذي لا يقابل الحب بالحب، لغة يردد أبناءها أنه لا مكان للمرأة إلا بيت الزوج ولا قيمة لشهادة أو عمل، ولا كلمة إلا للرجل الذي أصبح بين ليلة وضحاها ملجأً ومأوى ومحور وجود تتمركز فيه قوى الكون. وفي اللحظة التي تدرك أنك أمام هذه اللغة الشائكة، لغة تتسلق جدران وعينا كلص لتعيد رسم ملامح ثقتنا وشكل حقيقتنا، واضعة بذلك قوالب مسبقة لطبيعتنا ونظرتنا لأنفسنا، في تلك اللحظة تحديدًا ستدرك أنك أمام مشكلة حقيقية. ومن هنا يتوجب عليك أن تنطلق لكي تبحث في جذورها محاولاً بذلك خلق تصور أفضل لواقع الأغنية العربية وليس بالضرورة بديلًا عنها.
في مراجعة منهجية لأهم المقالات العلمية المنشورة في العشرين عامًا الماضية، قام بنشرها الباحث السويدي Rolf Lidskog عام ٢٠١٦ التي تناول فيها مواضيع تخص الهويات العرقية والثقافية والهجرة. بحثت هذه المراجعة عن دور الموسيقى في تشكيل الهوية ورسم معالمها. وأكدت على أن الموسيقى من أهم ما يساعد المجموعات على الانخراط والتلاحم ويأتي ذلك تبعًا لدورها في رسم هوية مشتركة بين هذه الجماعات. وهنا نطرح سؤالًا مهمًّا، وبعد التطرق لشكل اللغة المستخدمة في الأغنية العربية، ما الذي تقوله الأغنية العربية عن هويتنا كنساء؟ وقبل الانطلاق في البحث عن إجابات لهذا السؤال، يجب أن أؤكد إلى أن هناك العديد من الدراسات التي امتدت إلى ما هو أبعد من ذلك فقد تطرقت إلى أثر كلمات الأغنية على حالتنا المزاجية وردود أفعالنا وطريقة تعاطينا لمتغيرات اللحظة، هذا المجهود البحثي ينطلق من أهمية الالتفات لمشاعرنا كل يوم، وكل لحظة، والرسائل التي نوجهها -بوعي أو دون وعي- لعقلنا.
وللبحث في جذور هذه المشكلة، لنتأمل للحظة ولنسأل أنفسنا هل كلمات الأغاني اليوم هي ظاهرة لم يكن لها سابق وجود؟ هل مساهمتها في قولبة المرأة وتعزيز هذه الصورة النمطية عنها لهذا الحد أمر طارئ، أم أن أصوله تاريخية متجذّرة في موروثنا الثقافي؟
تناول الدكتور عبدالله الغذامي في الجزء الثاني من كتاب “ثقافة الوهم“ هذه القضية، قضية المرأة والجسد، واللغة الثلاثية التي تنتج لنا الحبكة في قصةٍ لا يعرف عن رواتها إلا ما تناقلته الأجيال وما تشكَّل لنا من جبروت رمزي -كما أسماه- متمثل في كل الصور النمطية من معتقدات وأفكار وآراء ووجهات نظر انغرست في الذهن وتحولت إلى مبادئ تقوم عليها شخصية المرأة اليوم. يوضح الغذامي كيف أن الثقافة بكافة صورها وأشكالها جردت الرمز الأنثوي من كل مقومات الحياة وجعلت منه صورة للجسد الخاوي من أي معنى، أن تلك الثقافة وعلى مدى أجيال متراكمة ربطت قيمة الأنثى الحقيقية في جمال وجهٍ أو جسد بمعايير محددة وما دونها قبح لايسر النظر. وأن وجود العقل -مناط التفكير- ما هو إلا كُفر بالمنطق الذي يفترض أن كائنًا كالمرأة هو دور مكمل للرجل وبطبيعة الحال وجوده لم يكن في الأساس إلا تبعًا له وبذلك ينفي الحياة عنه. وجود هذا الموروث الثقافي واعترافنا به يجعل من تحليل المشكلة أيسر -إلى حدٍ ما- فهذا التمثيل من خلال اللغة، هو جزء من تكويننا اليوم، وترسخ على مدى طويل حتى أصبح الهوية التي تعرفنا بها.
و في سبيل الخطوات الجادة الراغبة في إحداث أثر، لا أستطيع وصف عدد المرات التي رُمقت فيها بنظرات استنكار، وبأوصاف تذكّرني أن الحياة قصيرة، وأنه لا يجب علي الالتفات لتوافه الأمور، وأن كل الأشياء تمضي بطبيعة الحال فلماذا التدقيق على مجرد كلمات… ولكن هذا التجريد لا يلتفت به إلى ما هو أعمق وأخطر وإلى مافي طيات “مجرد الكلمات”.. إلى كونها القشة التي قصمت ظهر الحرف وانكسر فيها المعنى!
ولا يمكنني تذكر عدد المرات التي ذُكرت فيها بعبارات من قبيل “عيشي ومشيها” أو “ليش أنت نفسية؟” أو “استمتعي بالأغنية بدون تدقيق”. لا أنكر أن مثل هذه العبارات التي تستنكر موقفي قد تثير بداخلي أسئلة أبعد وأكثر عمقًا عن رأيي في هذا كله، ولكني أذكر نفسي في كل مرة أن أكون “نفسية” في سبيل أن أرتقي بالصورة التي يجب أن أنظر فيها إلى نفسي، أفضل من كوني أكثر استرخاءً وتقبلاً ودعمًا لهذا الجبروت الرمزي الذي يستنقص ويحط مني بدون اتخاذ أي موقف ضده. أنا اليوم أكثر إيمانًا من أي وقت مضى أن الجمهور هو من يمتلك القوة وهو واحد من أهم العوامل التي تساهم في مدى دوام واستمرارية المواد الفنية المعروضة ومدى غيابها، ولأني واحدة من ملايين الجماهير أؤمن أن وقفتي الفردية ضد هذه المواد الفنية لن تقوم بتغيير الكثير ولكنها مهمة لي بصورة شخصية وسبب في تذكيري دائمًا أن التغيير قادم وقد ينطلق من فرد واحد.
إن رفض الأغنية واستنكار كلماتها من الجمهور هي خطوة مهمة وفارقة في الصمود في وجه هذا الجبروت، لأنها تأتي انطلاقًا من الاعتراف أن “مجرد الكلمات” تلك ليس أمرًا بكل هذا التبسيط والسهولة، وأن الأثر الدامي خلفها يجب علينا أن نقف في مواجهته، وهذه المواجهة قد تقدم شكلاً آخرًا لهذا السلاح -سلاح الكلمة- وكيف من الممكن استخدامه. فليس بالضرورة أن يخلف الحروب النفسية بعده، بل قد يقدم شكلاً من أشكال التعاطف الحقيقي مع الإنسان وقضاياه، يعبر عنه وعن همومه، يشارك بصوتٍ عالٍ ما يقلق مضجعه، ويعبر بصورة واضحة وصريحة عن أفكاره. سلاح ليس سحري، ولكنه سلاح فعّال، أغنية بديلة!
أعتقد أن خطوة الأغنية البديلة خطوة خلّاقة في مساهمة تشكيل واقع اجتماعي أفضل، تربّت فيه الكلمة على كتفي الوجدان، وتساهم في خلق تصوّر حقيقي عن هوية الأشخاص في ذلك المجتمع. وبالتالي ترسم معالم مشاعرهم تجاه أنفسهم وحتى مجتمعاتهم، في سابقة مميزة في هذا السياق تناولت الأختان كرسواني في أغنية ”ساندريون“ بأسلوب ساخر ومميز، واقع الموروث الثقافي في أدب القصة الذي يختزل المرأة في قالب المرأة المظلومة، التي يمضي فيها العمر في انتظار أميرها الوسيم الذي سيحقق لها العدالة جالبًا بها السعادة الأبدية. وما تحمله هذه القصص من تفاصيل تغذّي هذه الصورة، فتطرح الأختان تساؤل مهم في الأغنية، “لماذا تُعلّم مثل هذه القصص للأطفال؟” وفي خطوة منهما لتغيير حقيقة نهاية القصة، تردد البطلة في القصة أنها لا تريد ”التاج والمرآة“ في محاولة لرفض الصورة النمطية وتطالب ”بالسيف والحصان“ لتحرير المدينة من بطش الوحش الذكوري.. في هذه الأغنية وقفت الأختان وقفة صادقة في مواجهة مشكلةٍ ما عن طريق استخدام الأغنية لمحاولة إيصال أصواتهما، وللمصادفة الرائعة كانت تناقش الأغنية واقع تلك الأفكار التي يبثها موروثنا الثقافي في وعينا، بالتأكيد أنه ليس بالضرورة أن تحل الأغنية البديلة محل الأغنية التقليدية، ولكن أعتقد أن وجود هذا الخيار مطروحًا يعني بشكل أو بآخر وجود الأمل لواقع أفضل للأغنية العربية تعبر فيه عنا كنساء وتساهم في تشكيل صورة حقيقية عن مشاعرنا ونظرتنا لأنفسنا ومقدار الثقة والتقدير الذي نستحقه.
وها أنا هنا اليوم، أحاول فهم كل ما يحدث، وأحاول إدراك كل ما يعتري مشاعري ونظرتي لنفسي من تغيير واختلاف لتقبله وفهمه والوصول إلى جذوره. أقف في مواجهة لغة وهوية، وأسأل نفسي وأسألكم، ماذا بعد؟